رأيت الوحش لأول مرة في 2005، في وسط القاهرة أمام سلم نقابة الصحفيين حيث تجمع عشرات من الشباب والفتيات للهتاف “كفاية”. خرج الوحش من سيارات الشرطة بملابس عسكرية، وأحياناً متنكراً بملابس مدنية، ضرب المتظاهرين، سحل الشباب، وفي الشوارع قامت قوات الأمن بتعرية المتظاهرات وهتك عرضهن. وقتها كانت الصدمة الكبيرة، وتخيلنا أن هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الوحش بنا، تخيلنا أن الكثير من الحب وتشجيع الآخرين على الانضمام لنا كفيل بأن يكبر جبهتنا من بضع مئات إلى مئات الآلاف وربما الملايين، وأن هذا كفيل بالقضاء على الوحش. هكذا كانت سذاجة الشباب وغروره بنقاء القلب وصدق المشاعر. وأنا، بدافع الاشمئزاز من خطابات الحماسة والمواجهة، كنت أنصرف عن كل معركة يظهر فيها الوحش.

قابلت السذاجة وصدق المشاعر قبل ذلك بخمس سنوات. كنت طالباً في المدرسة الثانوية، وفي عام 2000 شاركت في مظاهرة طلابية تضامناً مع انتفاضة الأقصى التي اشتعلت بعد زيارة المدان بارتكاب جرائم حرب ورئيس وزراء إسرائيل بعد ذلك “آرييل شارون” إلى المسجد الأقصى، واغتيال القوات الإسرائيلية للطفل محمد الدرة وهو في أحضان والده. كان المدرسون في المدرسة يشجعوننا، دون أن يشاركوا، على السير في مجموعات صغيرة غاضبة تهتف بالحرية لفلسطين، وتتوعد بعدم نسيان حق “الدرة”. وسمح لنا الأمن بفتح أبواب المدارس لنسير في مجموعات أكبر في شوارع مدينة “المنصورة” حيث قضيت مراهقتي. تملكت الأطفال وطلبة المدارس حولى نشوة وحماس ناتج عن انتزاع حق الصراخ وامتلاك الحرية في الشارع للمرة الأولى. وحينما كانت تختلط مجموعات الطلبة كانوا يبتسمون في بلاهة ويحيون بعضهم البعض ويتعانقون في أداء مسرحي مبالغ في افتعاله. مدارس الذكور، في المنصورة، مثلما في معظم أرجاء مصر، مُنفصلة عن مدارس الإناث، وكان من المدهش في المظاهرة مشاهدة كيف يختلط الجنسان من المراهقين للمرة الأولى في سياق آخر غير سياق انتظار الطلبة الذكور أمام مدارس الفتيات للتحرش أو الاصطياد أو المغامرات العاطفية. لكن الزحام، وضرورات الموقف بما تفرضه من زعيق وانفعالات، وتضخم ذوات أفراد بؤساء يحلمون بقيادة الهتاف، كل هذا جعلنى منفصلاً ذهنياً عن الجماعة رغم أنى كنت جزءاً منها.
بعدها بخمس سنوات وأنا أغادر المرحلة الجامعية، سأتعلم أن نظام مبارك كان يترك المظاهرات المعادية لإسرائيل، بل ويدعمها ويقودها أحياناً. لتصور الكاميرات الجموع الغاضبة وهى تحرق علم إسرائيل، ثم يشير مبارك لآلهة الإغريق في جبال أوسلو أو سهول واشنطن ويقول: “أنا هنا للسيطرة على هؤلاء الوحوش حتى لا يحرقوا كل شيء.” وحينما خرجت المظاهرات ضد مبارك كان الأمن يحاصرها، ولأنهم لم يكونوا وحوشاً بعد، فقد كان مبارك لا يزال يسعى لتحويلهم لوحوش من خلال محاصرة المظاهرات القليلة وتعرية السيدات والتعدي الجنسي على الشباب المشاركين فيها، ولكنهم بدلاً من أن يصبحوا وحوشاً فضلوا منطق الهزيمة والانتقام وتقمص حالة الضحية.
شعرت بسأم دائم، وبسخافة كل المسرحيات المعروضة والتي نُستدعي للمشاركة فيها، مسرحية للانتخابات، ومسرحية للرقابة على حرية العقيدة والجنس باسم الدين، ومسرحيات آخري تبتدع مفهوم الوطن وصورته وضرورة أن تحبه والكيفية التي يجب أن تحبه بها. كان هذا لا يناسبني، وعرفت بسبب الإنترنت آخرين غيرى لم يناسبهم الأمر، وفضّلنا صناعة أكاذيبنا الخاصة على الإنترنت، مساحة خارج رقابة السلطة ومغايرة لسأم وملل الآباء وأخلاقهم الراكدة. كانت مصر تمر بلحظات عظيمة. الجميع يتحدثون في التلفاز عن التحول الديمقراطي، وفي الزوايا المعتمة من عالمهم أخذنا نخلق مساحات صغيرة لنقيم فيها حفلاتنا ونعزف موسيقانا الممنوعة من البث في الإذاعات الرسمية والخاصة، لأنها لا تتحدث عن الحب والرموش والشوق والحنين. في واحدة من هذه الحفلات سيقترح علاء سيف أن ننشئ موقعاً إلكترونياً، هو نسخة من موقع الرئيس لكن بمحتوى ساخر ومضحك أقوم بكتابته. كانت هذه أنواع اللعب التي نمارسها، ندخل لقوقعتنا على الإنترنت، ونضحك على الملك العريان وحاشيته وعبيده الذين يمتدحون جمال ثوبه.
تعرفت على زوجتى الأولي في منتدى على الإنترنت لمحبي محمد منير. كنا مراهقين لا نتجاوز الثامنة عشر وقتها، وستمر عشرة سنوات تتخللها علاقة مضطربة أحياناً تشمل الزواج والطلاق ودورة حياة كاملة. أخرون بدأت دورة حياتهم من منتديات ومدونات للإخوان المسلمين، أو الاشتراكيين الثوريين، أو محبي فيتش أقدام النساء، أو جنود الشيخ أسامة بن لادن، أو منتدى “فتكات” لربات البيوت الشابات. عوضاً عن السأم المنبعث من لون صبغة الشعر السوداء لمبارك الذي لم يكن يتغير، كان الإنترنت يجمع الهائمين في أفلاك متقاربة، وهدير حديث وحوارات هذه المجموعات يتصاعد خافتاً. العجائز بأجهزة تقوية السمع وصفوا هذه الهمهمات بأصوات الشباب. نعتوا الشباب بالاغتراب، والعمالة، وقلة الأدب، ولم يتعاملوا معها بجدية أو ربما لم يفهموها رغم أنها كانت رسالة بسيطة..
“على الجثث القديمة أن تترك مكاناً للجثث الجديدة”.
الزومبي القدامى يحتلون كل المقاعد. كان هناك زومبي الجنرال، وزومبي الشيخ، وزومبي الرئيس، وزومبي رجل الأعمال، وزومبي الحزب الحاكم، وزومبي المعارضة، وزومبي الإسلام الوسطى، وزومبي الإسلام المتطرف. والخيارات التي يقدمها الزومبي للشباب هي أن يكونوا زومبي، ويغادروا مثالية الأحلام والأخلاق. كنا مضطرين أن نخالط الزومبي، ونبادلهم حديثهم، ونتودد لهم، ونمدحهم أحياناً حتى نأمن شرهم، نندس وسطهم بأطراف مجمدة، ننظر ولا نرى، بحد تعبير يوسف رخا بعد ذلك بسنوات في قصيدته الرائعة، وحينما نختلف معهم أو نرفض أن نأكل الجثث القديمة لمعاني الوطن والدين، يكون التعذيب والتهميش والحصار هو ما يواجهوننا به.
“عيشوا عيشة أهاليكو” يقول الزومبي. وعيشة أهلنا كما يصفها شادى عبد السلام في فيلم “المومياء” هي عيشة الضباع. تسير الفتاة وأكتافها محنية ورأسها للأرض، لا تلفتت يميناً أو يساراً، تتقبل المعاكسة والتحرش صامتة، وحينما ترفض الرضوخ للتحرشات الجماعية في قلب المدينة، يتهم الزومبي الضحية باجتذاب المجرم وإثارته. تخرج المظاهرات احتجاجاً على تعذيب الشرطة للمواطنين، ويُتهم المتظاهرون بإهانة الشرطة. كبرت المظاهرات ثم تحولت إلى المطالبة برحيل الزومبي وكبيرهم الذي علمهم صبغة الشعر. اجتمع الزومبي وخاطبوا الشباب قائلين: “اعتبره زى أبوك يا أخى.”
العواطف الجياشة وسهولة التأثر والانفعال العاطفي من سمات الشباب. ومثلما تكون العاطفة وقوداً للثورة، تدفع الدماء أحياناً في عروق الجموع الهائجة، فهى أيضاً تبعث الرحمة والعاطفة والشفقة. كانت تلك العواطف هى ما سيحول ما يلى الثورة إلى رحلة للبحث عن حق الشهداء والثأر، وستمنع الأبناء من قتل الأباء الزومبي.
في أكثر من صورة لبولين سنشاهد نقاشات محتدة بين فتيات وأمهات، وشباب وعجائز. في الصور لن يمكننا سماع ضجيج الصراخ والنقاش والاختلاف. لكن الصور توضح لنا مقدار السلطة التي امتلكها الآباء الزومبي، ومقدار العاطفة التي ظل هذا الجيل واقعاً تحت سطوتها.
عرفت شباباً وشابات ينزلون إلى الشارع يحرقون الإطارات ويتقدمون صفوف المواجهة ضد مجرمى الشرطة، لكن حينما يرن هاتفهم يهربون بحثاً عن مكان هادئ ليحدثوا منه أمهاتهم “أنا كويس وبعيد عن القلق”، ظناً أن التمرد واقع افتراضي يمكن خلقه داخل فقاعة بعيداً عن حياتهم الواقعية والعائلية. عرفت نشطاء في مجال حقوق المثليين جنسياً لديهم شجاعة إعلان ذلك في مجتمع كالمجتمع المصري، وخوض نقاشات ومجادلات أمام القضاة ووسط ضباط الشرطة، لكن ليس لديهم شجاعة إعلان ذلك أمام أمهاتهم أو آبائهم. صديقاتي اللواتى تلقى بعضهن رصاص الشرطة المطاطي بأجسادهن دون أن يسقط أصبعهن الأوسط المرفوع في وجه الشرطة، كن ينهرن من البكاء جراء ضغوط المجتمع والأسرة وصعوبة أن يخترن تصوراً لمستقبل حياتهن لا يشمل الزواج والإنجاب والاندماج في سياق دورة إنتاج الزومبي.
هذا الجبن وهذا التردد هما ما جعلا خيارات هذا الجيل دائماً تحاول إمساك العصا من المنتصف، ثم يأتي الآباء ليأخذوها كلها من أيديهم. صفقوا للاسلام الوسطى وصوتوا لمحمد مرسي، قال شباب الإسلاميين، الإسلام هوية ودين وسطى جميل يمكنه التعايش مع الديمقراطية، والعلمانية ليست من هويتنا الوطنية. ثم جاء الزومبي الكبار وقالوا: لا فرق بيننا وبين داعش، والقتلة في سوريا، نحن إخوة، سنقول عنهم مجاهدين وسنرسلكم للحرب معهم. وحينما صفق شباب النخبة المدنية للائتلاف المدنى بقيادة الجنرال العسكري، وقالوا: انظروا لعيون السيسي، إنها تشع حباً ودفئاً وسينقذ هذا الوطن ويبنى مصر دولة مدنية على الطريق نحول العلمانية، منع الجنرال الحديث أو الكلام ووضعهم داخل السجون، والباقي قتله حرقاً في الميادين أو على بوابات الاستاد.
الجنرال لم يكن ذكياً، لكن من خلفه وقف شيوخ الخليج، وكلاء الآلهة الإغريق في المنطقة. هؤلاء، مع الزومبي والجنرال، قرروا أن لا يتركوا للشباب حتى مساحات الواقع الافتراضي على الإنترنت. فُرضت الرقابة على الإنترنت، وجملة واحدة على تويتر قد تودى بك إلى السجن. ضخوا داخل الإنترنت ذاته عشرات ومئات الملايين، بحيث تحول لمول كبير، هم من يتحكمون فيما يعرض فيه من خلال شركات وفرق “السوشيال ميديا” التي أصبحت تصنع الآن الموضوعات الرائجة على الإنترنت. وهكذا، فحينما تظهر قصة تعذيب جديدة من داخل السجون المصرية، تختفى تحت التكرار وضغط بث الأخبار حول الأشكال الجديدة التي يمكن لمؤخرة كيم كاردشيان أن تأخذها.
شعرت منذ أسابيع بآلام خفيفة لكن مستمرة في خصيتى اليسرى، وحينما زرت الطبيب أخبرنى أني أعانى من دوالى الخصية، ويجب ألا أقف لفترات طويلة وأن أقتصد في ممارسة الجنس، ولا أعرضه لفترات انتصاب طويلة، وحينما سألته عن السبب في كل ذلك قال الجملة ببساطة دون أن يرفع عينيه عن أوراقه: “غالباً أسباب وراثية وعامل الزمن”.
لا فترات انتصاب طويلة لهذا الجيل بعد اليوم، مشتتون هم اليوم في الأرض. البعض في السجون، والبعض منفيون، والبعض يستعدون للغرق أمام سواحل أوروبا المتوسطية، وآخرون يبحثون عن طريق للخروج من الجحيم نحو جنة الله الموعودة عن طريق صناعة سلم نحو الله من الرؤوس المقطوعة. أما من بقوا فقد نجحوا في انتزاع بعض الأماكن من الجثث القديمة، ويمارسون الآن دورهم كزومبي، يظهرون في التلفاز كممثلين للشباب، يلتقطون السيلفي مع كبار الجنرالات الزومبي وكبار الشيوخ الزومبي، ويتنافسون على التقاط الفتات الذي يلقيه الأمير أو الشيخ الخليجي عليهم من وقت للآخر.
هذا أوان التوثيق، الأرشفة، والحفظ. ثم لنودع الماضي والشباب. لنودع الأحزان، لنودع الأشباح. لنبحث في الداخل عن ثورة ومسار جديدين. الخطر الأكبر يكمن في الاستسلام للحنين، في الالتصاق بالمبادئ والأفكار القديمة، في تصور أن هناك لحظة ذهبية ونقية في الماضي يمكن استعادتها. الخطر الأعظم هو تقديس الصورة. أي من هذه الخيارات، حتى لو شملت أشكالاً أخرى من التقديس، كالثورة أو الشهداء أو القيم العليا للأيديولوجيا، كفيل بتحويلك لزومبي دون أن تشعر.
—————————————–
*نُشر هذا النص بالفرنسية كمقدمة لكتاب فوتوغرافيا صدر مؤخراً للمصورة البلجيكية بولين بوني بعنوان “جيل التحرير“، تتبعت فيه، على مدار خمس سنوات، حكايات متنوعة لمجموعات من الفنانين والسياسيين أثناء سنوات الثورة.



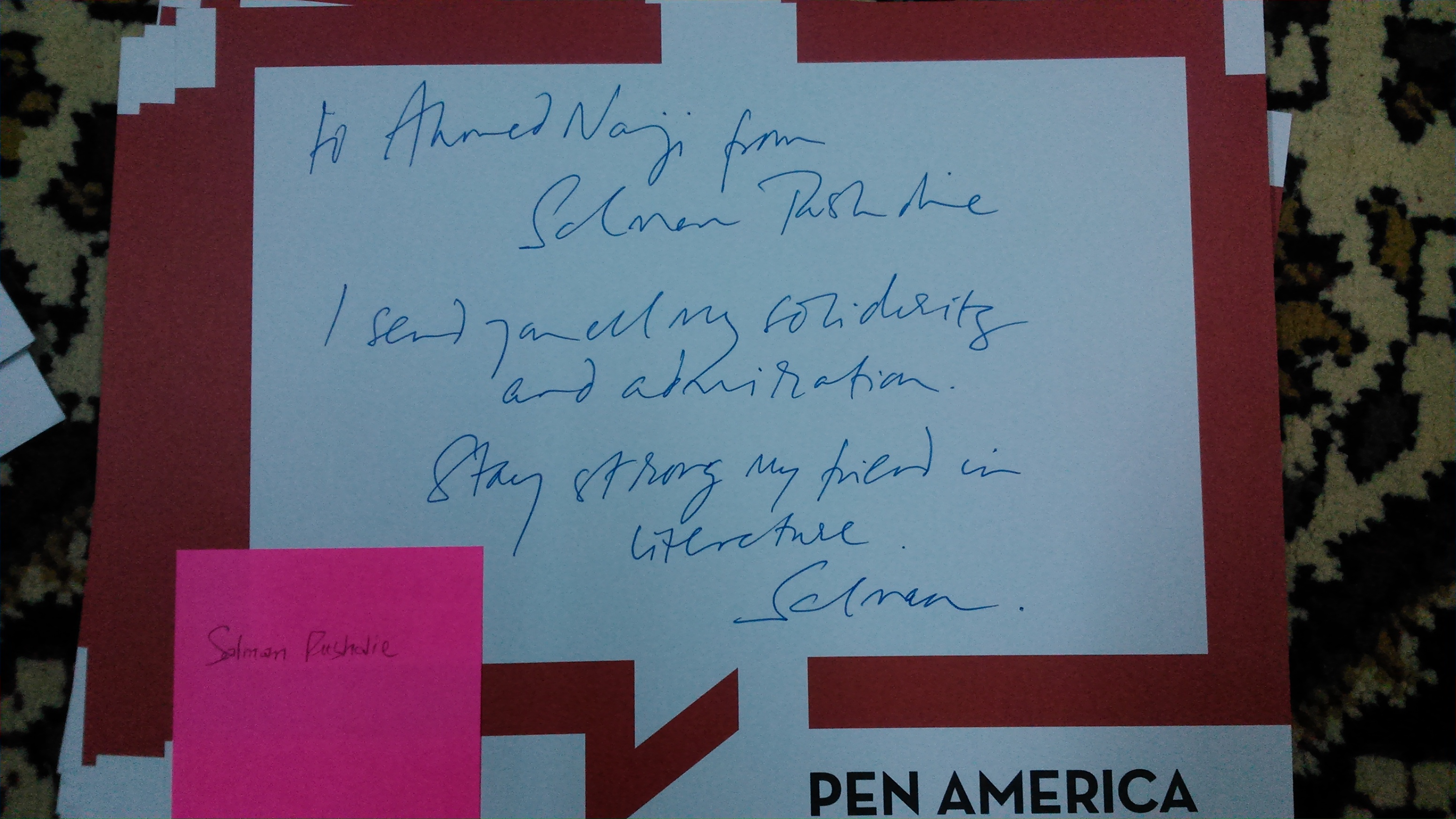
 st, you say. Tens of thousands of his fellow citizens rot in jail, where they are being abused in all sorts of ways, without any due process or a parody of it — some for
st, you say. Tens of thousands of his fellow citizens rot in jail, where they are being abused in all sorts of ways, without any due process or a parody of it — some for