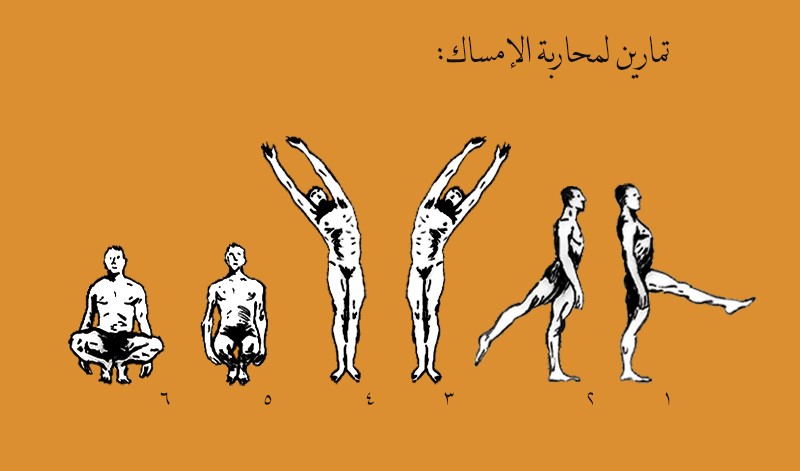إليكم هذا اللغز؛ هل الخيال العلمي:
- تصور للمستقبل ينطلق من ظاهرة أو نظرية علمية في الحاضر، فتكون النتيجة عالمًا أدبيًّا مختلفًا عن واقع لحظتنا لكن يعمل وفق قوانينها “العلمية”، أو بلغة أخرى كما تقول Ursula K. Le guin:
[1]غالبًا ما يتم وصف الخيال العلمي، وحتى تعريفه، بأنه استقراءي. يأخذ كتاب الخيال العلمي اتجاهًا أو ظاهرة هنا والآن، ويقومون بتنقيتها وتكثيفها لتحقيق تأثير درامي، وتوسيعها إلى المستقبل
- 2. العالم محكوم بقوانين فيزيائية وحسابية، وأدب الخيال العلمي هو تخيل طرق علمية بديلة لتجاوز قبضة الواقع.
- 3. الخيال العلمي هو مجموعة من الثيمات الدرامية والحبكات الأدبية تتكرر في آداب الدول الشمالية، أما إن ظهرت الثيمات والحبكات نفسها في أعمال أدبية من دول الجنوب تصبح “واقعية سحرية” أو “فلكلور”.
- 4. يمكن تمييز أدب الخيال العلمي عبر مجموعة من المحددات كما تقول باربار ديك [2]
العوامل المميزة للخيال العلمي هي توجهه نحو استخدام العلم والتكنولوجيا، وغالبًا ما يركز بشكل خاص على المستقبل، طالما أن استخدام العلم والمستقبل جزء لا يتجزأ من الدراما.
الآن إليكم قصة قصيرة، فهذه مقدمة لكتاب قصصي، وليست ورقة امتحان
في صيف 2010 أوقف اثنان من رجال الشرطة في ثياب مدنية الشاب خالد سعيد في الإسكندرية لتفتيشه، وحين طلب منهما تحقيق الشخصية ليتأكد من كونهما شرطيين، انهالا عليه بالضرب أمام كل من في الشارع، ثم جرَّاه إلى مدخل إحدى البنايات واستكملا وصلة الضرب، حتى تركاه جثة هامدة في مدخل البناية.
التعذيب كان وما زال ممارسة منهجية لدى الشرطة المصرية، ولم يكن خالد سعيد الضحية الأولى ولا الأخيرة، لكن ردود الفعل على الحادثة اتسعت خارج الدائرة الحقوقية، لتشمل مجموعات شبابية نظموا أنفسهم باستخدام الإنترنت والسوشيال ميديا، في مظاهرات خرجت للشوارع وبدأت في الاتساع، خصوصًا وقد أنكرت وزارة الداخلية الاتهامات، وخرج تقريرها يقول إن خالد سعيد توفي بسبب ابتلاعه لفافة بانجو.
بعدها بنحو 6 أشهر اندلعت مظاهرات مليونية في القاهرة وعدد من المحافظات، وتحولت المطالب من إعادة محاكمة القتلة وعزل وزير الداخلية إلى إسقاط النظام والمطالبة برحيل الرئيس مبارك، الذي كان يحكم البلاد لأكثر من ثلاثين عامًا ممثلًا عن الجيش، الذي يملك ويحكم مصر منذ سقوط الملكية في 1952.
استمرت المظاهرات لمدة 18 يومًا، انتهت بتنحي مبارك عن السلطة يوم 11 فبراير 2011، لتنتهي شرعية السلطة القائمة وتحل بدلًا منها شرعية جديدة لما صار يعرف بثورة 25 يناير.
أجريت انتخابات شبه ديموقراطية انتهت بفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بهامش بسيط، وقد كان مهندسًا في مجال الفلزات وتخصص في تطوير الأسطح المناسبة لصواريخ الفضاء.
فور وصوله إلى الحكم أصدر عالم الفلزات مجموعة من القرارات الإمبراطورية بهدف الاستحواذ الكامل على السلطة، وتحويل مصر إلى إمارة إسلامية طبقًا لمفهوم جماعته. خرجت المظاهرات مرة أخرى ضده، وهذه المرة انضم إليها الجيش وقوى إقليمية خليجية، فانتهت التجربة شبه الديموقراطية بانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا لفترة استمرت عامًا، وانتهت بفوز الجنرال السيسي بانتخابات معدومة الديموقراطية، ليحكم السيسي مصر منذ 2014، بقبضة من الحديد والنار، وعقل يعشق الخرافات وتفسير الأحلام، ويرفض دراسات الجدوى ويرى أن العلم والتعليم استثمار خاسر ولا يدر أرباحًا.
في العام الانتقالي الذي حكم فيه السيسي وزيرًا للدفاع إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية، وبينما تمتلئ الشوارع بالاشتباكات المسلحة والحروب الأهلية المصغرة بين مؤيدي الرئيس عالم الفلزات والجنرال عاشق الأحلام، استيقظ المصريون على أخبار عن مؤتمر صحفي هام للقوات المسلحة ستعلن فيه عن هدية منها لا للمصريين فقط بل للإنسانية جمعاء.
في هذا المؤتمر ظهر بلباس عسكري شخص عرف نفسه بصفته اللواء دكتور عبد العاطي، أمسك في يده جهازًا يشبه الريموت كنترول يخرج منه أريال TV antenna، ليعلن أن القوات المسلحة ابتكرت هذا الجهاز الذي يمكنه الكشف عن أمراض التهاب الكبد الوبائي والإيدز، من دون الحاجة إلى إجراء تحاليل، فقط بتمرير الجهاز تتحرك “الأنتينا” إذا كان لدى المريض فيروس كبدي أو إيدز.
أعلن اللواء دكتور عبد العاطي أنه يعكف على جهاز آخر سيقضي على الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والأمراض الفيروسية الأخرى. أمام الكاميرات ومختلف محطات وسائل الاعلام شرح أن جهازه سيمكنه عبر الأشعة تفكيك وتكسير بروتين الفيروس، ثم تحويل هذا البروتين إلى غذاء للجسم، أو كما قال “هناخد الفيروس من المريض، أرجَّع له بروتين كباب وكفتة يغذيه ويفيده”.
صمتت المؤسسة الطبية المدنية ولم تعلق، فقبل الإعلان عن الجهاز ببضعة أسابيع، قتلت القوات المسلحة أكثر من ألف شخص في مذبحة ميدان رابعة، وأمام الكاميرات أشعلت القوات خيام المتظاهرين وجثثهم. ومنذ المذبحة وحتى الآن غاب أي مظهر من مظاهر القانون عن أداء الشرطة أو الجيش المصري، وتوسعا في عمليات القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وسجن أى معارض لسنوات من دون محاكمات ولو حتى صورية. تحت سلطان الخوف صمت الجميع، بل صفق بعض الأطباء وأساتذة الجامعة لاختراع القوات المسلحة القادر على تحويل الفيروسات إلى كباب وكفتة.
كنت وقتها أعمل على روايتي الثالثة “والنمور لحجرتي”، والشخصية الرئيسية طبيبة علاج طبيعي في مستشفى عسكري، تكتشف ذات يوم قدرات علاجية خارقة للمسة يدها، فتخوض رحلة للتعافي من طلاقها ومعرفة سبب هذه القدرات المفاجئة، لكن أمام أخبار اختراع اللواء عبد العاطي، بدا الخيال العلمي الذي أكتبه محدودًا جدًّا مقارنةً بالواقع.
ما الذي يمكن أن يصنعه أدب الخيال العلمى في مواجهة سلطة استبدادية تستلهم مشاريعها من الخيال العلمي؟ من “نيوم” في السعودية إلى مشروع “عقل مصر”، يبدي الديكتاتوريون العرب شغفًا غير محدود بجماليات وأدبيات الخيال العلمي، ويستلهمون منها فانتازيا أحلامهم السياسية، التي تصبح كابوس حياة المواطنين.
كيف يمكن لكاتب خيال علمي أن يتعامل مع هذا الواقع أصلًا؟ كيف يمكن أن “تتخيل” في واقع يخرج فيه قادة عسكريون وأطباء جنرالات ليقنعوك بجهاز يلتقط ذبذبات الفيروس، ثم يفكك بروتينه، ويحوله إلى كفتة، وإذا رفضت منطقهم، علمهم، فمصيرك السجن أو القتل؟ ما العلم وما الخيال في واقع كهذا؟
أسئلة مرة أخرى، لذا إليكم مقال أدبي قصير، ففي النهاية يفترض أن تكون هذه مقدمة لكتاب قصصي.
أعتقد – وقد تكون هذه مبالغة – أن التصور الخطي عن الزمن هو العمود الفقري للبنية اللغوية للإنجليزية، فكل جملة يجب أن تحدد موقعها بدقة على خط الزمن، المستقبل مثلًا يمكن أن يكون Simple future tense, Future continuous tense, future perfect tense and the mysteries future perfect continuous tense.
لذا من السهل على كتَّاب ونقاد الإنجليزية تخيل أدب الخيال العلمي كاستشراف للمستقبل، مثلما تقول Ursula K. Le Guin. لكن للزمن تصورات غير خطية في حضارات أخرى، كأن يكون دائرة مثلًا وكل نهاية/ موت إنما هي انتقال لحياة جديدة، أو فضاء يمكن للماضي والحاضر والمستقبل الاجتماع فيه، مثل حكاية الإسراء والمعراج في التراث الإسلامي، فبعد وفاة زوجة النبي محمد الأولى وعمه، يصاب بحزن شديد حتى يجد أمامه ذات ليلة “البراق”، وهو حيوان أكبر من حمار وأقل من حصان وله جناحين.
على ظهر البراق يسافر النبي إلى القدس، وهناك يجد الأنبياء جميعهم – الذين يفترض أنهم عاشوا وماتوا في الماضي – ينتظرونه ليصلي بهم، ثم بعد الصلاة يصعد مع الملاك جابرييل إلى السماء السابعة، وفي طريقه يشاهد أناسًا يعذَّبون في النار أو يتنعمون في الجنة فيما يفترض أنه المستقبل بعد يوم القيامة، ثم يعود من رحلته إلى فراشه قبل أن يبرد.
في التصور الخطي للزمن هذه القصة مستحيلة، بل تفتقد إلى منطق سردي. لكن في المفهوم الإسلامي فالزمن حيز يعيش داخله الإنسان، أما الملائكة والإله فهم خارج ذلك الزمن، ولذلك فلدى الله القدرة على رؤية الماضي والحاضر والمستقبل مهما كانت أفعال واختيارات البشر الذين يحيون داخل فضاء الزمن، وبقدرته يمكن أن يجتمع الأنبياء الذين ماتوا في الماضي، مع نعيم جنة المستقبل التي يفترض أن تأتي بعد القيامة ونهاية الزمان. ثم بعد انتهاء الرحلة يعود النبي إلى فراشه في مكة في الليلة ذاتها، حتى إن فراشه الذي غادره لم يبرد بعد.
ينعكس هذا التصور للزمن الذي تختص به الثقافة العربية في أدب الخيال العلمي المصري، فواحدة من أوائل الأعمال الرائدة هي “عجلة الأيام” ليوسف عز الدين عيسى، التي صدرت في 1939، وتبدأ بمشهد لزوجين عجوزين يتأملان غروب الشمس حين يلاحظان أنها تتحرك باتجاه الشرق لا الغرب، وأن عجلة الزمن تعود إلى الوراء، فالأمس يصبح غدًا، ولحظة الميلاد تصبح لحظة الموت، والماضي يصبح المستقبل.
إذا وضعنا هذه القصة على مقياس Ursula K. Le guin، لن يمكننا تحديد لحظة المستقبل عن الماضي.
في البدايات الأولى لأدب الخيال العلمي المصري، تتجلى حيرة الكتَّاب المصريين بين التصورات الغربية للزمن والزمن في تراثهم الأدبي، ومن هذه الحيرة ولدت الموجة الأولى لأدب الخيال العلمي المصري كما تتجلى في أعمال توفيق الحكيم (1898- 1987)، مثل “أهل الكهف” التي تستلهم قصة من الميثولوجيا الإسلامية عن ثلاثة دخلوا للنوم في كهف، وحين استيقظوا كان قد مر على العالم 300 عام. يتكرر الأمر في رواية نهاد شريف (1932- 2011) “قاهر الزمن”، إذ يتوصل طبيب ثري إلى التقنية التي يمكنه عبرها تجميد الجسد البشري لسنوات وعقود، حتى تنتصر الإنسانية على كل الأمراض وتصل إلى الخلود، فيعيد إحياء نفسه ومن اختاره ليعيشوا في المستقبل الخالد.
وهب نهاد شريف حياته لأدب الخيال العلمي، وعمل منذ الستينيات صحفيًّا متخصصًا في تغطية الموضوعات العلمية في جريدة أخبار اليوم، ومستشارًا لحكومات عبد الناصر في عدد من المشاريع الإصلاحية، مثل مشاريع القرية النموذجية، ومديرية التحرير، وهي مشاريع طموح هدفت إلى ابتكار مفهوم جديد للقرية والمجتمع الزراعي في إطار اشتراكي لتعليم الفلاحين وتطوير حياتهم، عبر وضعهم في قرى مهندسة كنموذج مستقبلي لما يجب أن تكون عليه القرية.
تعطلت وتوقفت تلك المشاريع مع حرب 1967 ونهاية مشروع التحرر الوطني والإصلاح الذي قاده جمال عبد الناصر، لكن مع مجيء السبعينيات ظهر جيل جديد من كتَّاب الخيال العلمي، أبرزهم د. مصطفى محمود، ورؤوف وصفي، وصبري موسى، كما أصبحت ثيمات الخيال العلمي جزءًا أساسيًّا من فسيفساء الأدب المصري الحديث، يتطرق لها ويستخدمها كتَّاب لا يصنفون أنفسهم أو أعمالهم كخيال علمي، مثل رواية “شطح المدينة” لجمال الغيطاني (1949- 2015)، “لست وحدك” ليوسف السباعي (1917 – 1978).
لكن انفجار أدب الخيال العلمي المصري وتحوله إلى أدب شعبي بدأ في الثمانينيات، حين نشرت المؤسسة العربية الحديثة إعلانًا تدعو فيه الكتَّاب المهتمين بكتابة أدب الخيال العلمي والقصص البوليسية وأدب الرعب إلى التقدم بمسوداتهم للمؤسسة.
في الأصل كانت المؤسسة العربية الحديثة دار نشر متخصصة في نشر الكتب التعليمية، لكن في عام 1983 نشرت لنبيل فاروق أول عدد من سلسلة رواياته “ملف المستقبل” الموجهة للنشء، وتدور أحداثها في المستقبل مع مغامرات فريق من ضباط المخابرات العلمية المصرية. صدر من سلسلة ملف المستقبل أكثر من مئة كتاب، وكتب نبيل فاروق سلاسل مغامرات وروايات منفردة ذات طابع بوليسي أو خيال علمي، لكن جميعها تميزت بالطابع القومي، فمعظم أبطاله ضباط في جهاز المخابرات، أو ذكور شجعان أذكياء. ومع بداية عقد التسعينيات انضم إلى نبيل فاروق (1956- 2020) كتَّاب آخرون مثل محمد سليمان عبد الملك، ورؤوف وصفي، وأخيرًا د. أحمد خالد توفيق (1962- 2018)، الذي صار من أكثر الكتَّاب العرب مبيعًا وتأثيرًا في الأجيال اللاحقة، وصاحب ألقاب مثل “عراب أدب الخيال العلمي العربي”.
باعت روايات المؤسسة العربية الحديثة ملايين النسخ في أرجاء العالم العربي كافة، وصنعت قاعدة شعبية للآداب النوعية، لكنها خلت من أي أسئلة اجتماعية تخص الجندر أو الجنس أو الدين أو السياسة، بالعكس تمتلئ بالخطابات القومية والأفكار الأخلاقية الرجعية. وبحكم توجهه لجمهور النشء، سعى أحمد خالد توفيق وكتَّاب المؤسسة لتحييد أي أفكار مثيرة للقلق.
فقط في عقده الأخير، تحرر د. أحمد خالد توفيق من المؤسسة العربية الحديثة، وبدأ في نشر روايات موجهة إلى الكبار تميزت بطابعها “الديستوبيا”، مثل روايته “يوتوبيا”، التي تصور فيها مصر مستقبلية يعيش فيها الأغنياء داخل تجمعات سكنية بأسوار عالية، ويُمنع على الفقراء دخولها، بل يعيشون في واقع مزرٍ يسوده الجهل والتلوث ويختفي منه العلم والمنطق والتعليم، في حين يكون العلاج بالأحجية والأدعية. نشر أحمد خالد توفيق روايته عام 2008، وبعدها بثلاث سنوات قامت ثورة 25 يناير، وبعدها بخمس سنوات انقلاب 30 يونيو. حاليًّا يبني السيسي عاصمة جديدة في قلب الصحراء، محاطة بسور ضخم، وخندق لمنع تسلقه، ويحتاج المصريون إلى تذاكر وتصريحات خاصة لدخولها.
في العقدين الأخيرين، حدث انفجار في الآداب النوعية في سوق الكتاب المصري، خصوصًا أدب الرعب والخيال العلمي، سواء عبر مشاريع كتَّاب تخصصوا في كتابة الخيال العلمي فقط، أو كتَّاب صارت الاستعانة بتيمات الخيال العلمي جزءًا أساسيًّا من عالمهم الروائي.
لذا حاولنا في هذه المختارات تقديم كتابات تعكس تنوع المشهد الأدبي المعاصر، لا فقط أدب الخيال العلمي المصري، وساعدنا في هذه التيمة التي تحكم السلسلة +100.
اخترنا دعوة كتَّاب متمرسين في كتابة الخيال العلمي، مثل ميشيل حنا، وكتَّاب معروفين بأعمالهم الواقعية مثل نورا ناجي وعزة سلطان، وآخرين عُرفوا بأعمالهم السياسية والساخرة مثل بلال فضل. كذلك راعينا التنوع الجغرافي، فبعضهم مقيم في القاهرة، وبعضهم خارجها، وآخرون في المنفي خارج مصر. ولأن الأدب المصري لا يقتصر فقط على الأدب المكتوب وبالعربية، وجهنا دعوة إلى كتَّاب مصريين يكتبون بالإنجليزية مثل ياسمين الرشيدي.
تجمع هؤلاء الكتَّاب مصريتهم وتورطهم على نحو أو آخر في ثورة 25 يناير، التي قلبت عالمهم وأعادت تركيبه من جديد. طلبنا من الكتَّاب المشاركين تخيل مصر 25 يناير لكن بعد مائة عام، لم نضع أي حدود أو إرشادات سوى ضرورة أن تتقاطع القصة مع لحظة مستقبلية هي 25 يناير 2111، فكانت النتيجة قصصًا تقف في المستقبل لكن تستلهم من الحاضر أحلامها وكوابيسها.
[1] Ursula K. Le guin at the introduction of her novel The left hand of darkness.
[2] DICK, BARBARA,KATHLEEN (2016) Modern Arabic Science Fiction: Science,